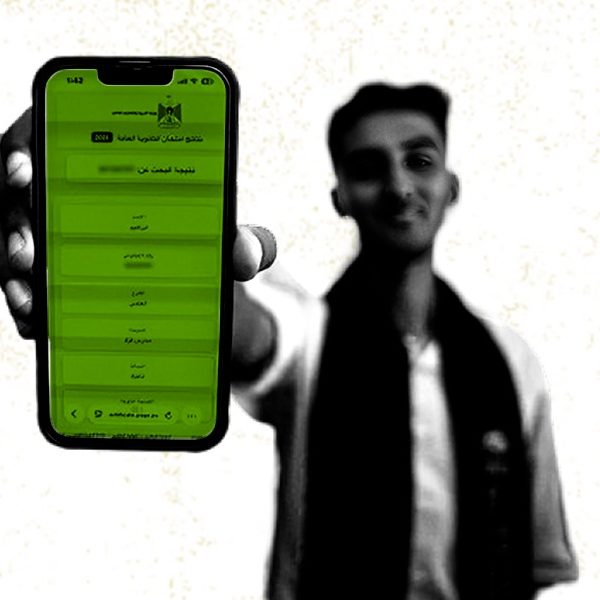ياسمين الأزرق
بيت، منزل، دار.. كُل الكلمات في معجم اللغة لن تصفَ معنى البيت الذي يبنيه أهله بالذكريات، ويؤسسون فيه حياةً واضعين أساساتٍ متينة له، بيتٌ يُبنى بالحب واللحظات العائلية الحلوة منها والمرّة إن انهارَت جدرانه وصار رُكاماً، فمن يكنسُ هذا الركام من قلوب أهله؟
في الحروب يتمتم الناجي بعد كل غارة حربية بالحمد لنجاته، يتحسّس ما نجا من جسده ويسأل عن الأحباب من عاش أو فُقد، وقبل أن يرتاح تداهمه غارة أخرى، فلا ينعى الذي أخذته السابقة ولا يأخذ نفسًا ليدرك ويلاته بسبب الغارة الثانية! لكن من ينعى البيوت التي هُدمت فوق رؤوس الذكريات؟ ومن يطبطب على من نجا بجسده حين ماتَ غيره، لأنه فقدَ بيتًا حين فقد الآخر عزيزًا.. يراه المشاهدُ من بعيدٍ جماداً ويردد “في المال ولا في العيال”، غير آبه بثمن البيت الحقيقي وهو “الذكريات”، وكما قال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش:
“بدقيقة واحدة ، تنتهي حياةُ بيتٍ كاملة.
البيتُ قتيلاً هو أيضاً
قَتْلٌ جماعيّ حتى لو خلا من
سُكَّانه.”
“الحقيبة لا تتسع…. كيف أطوي جدران بيتي!”
بيسان عبد الرحيم نتيل (27 عامًا) كاتبة شابة من غزة، كتبت قبل الحرب عن حبها للحياة، شروق الشمس، دفاعها عن الثقافة والفن، عن حصيرة جدتها ومنزلِها القابع في المخيم، وأحلامِ أطفال مدينتها، وأنشطتها الثقافية، عن البحر الواسع والعائلة وعن الأمل، ثم فجأة تغيّر النص والصورة، كأن الشمس قد غربت دون أن تلوّن السماء باللون الأحمر المبهج، فكتبت في الثامن من أكتوبر عن واحدٍ من أكبر مخاوفها:
“الحقيبة لا تتسع…. كيف أطوي جدران بيتي!
أريد ان أذهب بنا للأمان
وأي حقيبة تتسع لكل الكتب وصورنا والذكريات!”
وفي بداية شباط/ فبراير، تحقّقت مخاوفها فبعد أشهر من النزوح، ومع استمرار الحرب على غزة، دمّر الاحتلال الإسرائيلي بيت بيسان، فكتبت رثاءها الأليم:
“اليوم الثالث من شهر فبراير 2024، فقدت في اليوم الاول من الشهر بيتي! لم يعد لي بيت.
عزيزي البيت القابع غرب الكرامة، شارع الخزندار بالقرب من أرض المحاربين القدامى، أكتب لك من خلف وهم الممر الامن، من خلف الموت الذي يلاحقنا، من خلف الدمار. وأعرف انك لا تريد مني رسالة مادامت أبنتك العاقة التي تركتك في أصعب الأوقات لم تتنيك وتطويك لتضعك في حقيبتها لتدرك حقيقتها أنها خائنة، ولكنني في الحقيقة كنتُ خائفة. أعرف آسفي لن يعيد عمدان البيت، ولا ألومك على الوقوع.
هذه رسالة تعزية لكل تفاصيلك المتروكة تحت الركام والمدفونة فينا مادمنا قادرين على التنفس. “
“الجنود كانوا فيه… كل اشي مهم فيه سرقوه”
أما رهف اقديح (17 عامًا) طالبة ثانوية عاملة من شمال غزّة، ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها قناة على (اليوتيوب) كانت تنشر قبل الحرب يومياتها في منزلها وروتينها للدراسة، وبعض المقالب العائلية، وأجواء الشتاء -فصلها المفضل- الذي تحوّل للفصل الأكثر قسوة على جسدها النحيل، ها هي اليوم تنشرُ مقطعًا مصوّرًا تقارن فيه منزلها قبل الحرب وخلالها، وتكتبُ رثاءها
“بعد شهور من النزوح من بيتنا، اليوم وصلتني هاي الفيديوهات إله!!! تبين إنه الجنود كانوا فيه وما خلوا اشي في محله وكل اشي مهم فيه سرقوه”.
“ما فرحنا ولا انا فرحت حتى شوف البيت الي تعبت فيه”
وبعضهم مثل محمد أبو نحل، الذي وصله خبر هدم منزل عائلته وهو في الغربة بعد ثمانية سنوات وهو يعمل مغتربًا ليرسل إلى والده المال كي يساهم ببناء منزلٍ لعائلته، نعى منزله في أكتوبر “الحمد لله اليوم تم تدمير بيتنا بشكل كامل”.
“قبل شهر و نص بالضبط خلصنا البيت بناء وعفش جديد وضحكات أمي وفرحتها معبية البيت، جدران البيت فرحان.
كل شي صار كل شي جديد خلصنا بعد تعب سنوات بس…
ما فرحنا ولا انا فرحت حتى شوف البيت الي تعبت فيه”
“كان عندي بيت كثير لطيف، كل زاوية فيه إلنا ذكريات”
أما دعاء، وهي أم لطفلين، التي جمعت ذكرياتها في منزلِها الصغير، وبنته بالذكريات طوبة طوبة، وحجرًا فوق الحجر، نعت منزلها الذي دمّره القصف الإسرائيلي، وكتبت: “كان عندي بيت كثير لطيف، كل زاوية فيه إلنا ذكريات”.
ووصفت حبها للتفاصيل الصغيرة في منزلها الدافئ “بتعلق كثير بأشيائي، بحب كنبي، طقم النوم، سجادتي، ستايري.. حتى مفارشي بختارهم بعناية”، وككل الأمهات الفلسطينيات، لديها ذات العادة أن تُخبّئ أطقم الزجاج المميّزة للأوقات المميّزة، سواء حين يحلّ على بيتها ضيوف، أو حين تبحث عن لحظة هدوء وسط ضجة الأيام العادية، فنعت دعاء فناجينها التي أحبّت، وقالت “ومن بينهم هالفناجين، غاليين كتير على قلبي، بشرب فيهم القهوة وبرجع بخبيهم”.
إن البيوت تُنعى، وتُسرق روحها كما نفقدُ البشر في الحروب المُدمّرة، وتموتُ هي الأخرى مثلما يموت أصحابها، فكما قال درويش “ذاكرةُ الناس التي أُفْرِغَتْ من الأشياء،
وذاكرة الأشياء التي أُفْرِغَتْ من الناس… تنتهي بدقيقة واحدة.
أشياؤنا تموت مثلنا.
لكنها
لا تُدْفَنْ معنا!”.